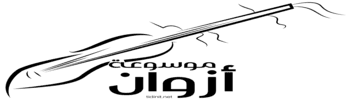اتروسي واللف والنشر.. جدلية التطابق والاختلاف

يُعنى علم البديع بجمال اللفظ والمعنى، وبذلك يندرج تحته قسمان يهتم أولُهما بتحسين الألفاظ، فأخذ اسمه منها وصار يعرف عند الدارسين بـ “المحسنات اللفظية”، ويهتم ثانيهما بتحسين المضامين أو المعاني فأخذ اسمه منها كذلك وصار يعرف بـ “المحسنات المعنوية”.
وقد عرّف ابن خلدون علم البديع على أنه “نظرٌ في تزيين الكلام وتحسينه على نوع من التنميق، إما بسجع يفصّله، أو تجنيس يشابه بين ألفاظِه، أو ترصيع يقطعُ أوزانه، أو تورية عن المعنى المقصود…”
وعرّفه محمد بن عبد الرحمن في كتابه “التلخيص” على أنه “علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة”
واستنادا إلى ما يفهم من التعريفين السابقين يتضح أن “اتروسي” و”اللف والنشر” ينتميان إلى هذا العلم دون شك، ولكن هل يعني ذلك أنهما متطابقان كما يزعم البعض، أم يجمعهما هذا العلم على اختلاف في الماهية والأسلوب كما يرى آخرون؟
الشائع المنتشر بين “لمغنين” وبعض المهتمين بالشعر الحساني هو عدم وجود فرق بين الأسلوبين، إذ يمكن استخدام أي منهما للتعبير عن الآخر، ولكنّ المتأمل لطبيعة كلّ واحد منهما يلاحظ فرقا لا يحتاج كبير جهد للوقوف عليه.
اللف والنشر
اللف والنشر بتعبير الدكتور عبد العزيز عتيق في كتابه “علم البديع” هو “ذكر متعدّد على التفصيل أو الإجمال، ثم ذكر ما لكل واحد دون تعيينه، ثقة بأن السامع يرده إليه لعلمه بذلك من خلال القرائن اللفظية أو المعنوية”
وهو بذلك ينقسم إلى نوعين: أحدهما يبدأ بذكر مجمل، لن نخوض فيه لوضوح عدم الارتباط بينه وبين “اتروسي” الذي لا يكون إلا من خلال ذكر متعدد. أما ثانيهما الذي يبدأ بذكر متعدد فينقسم إلى ثلاثة أقسام:
اللف والنشر المرتب:
ومثاله قوله تعالى {وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ} فالسكون راجع إلى الليل والابتغاء من فضل الله عائد إلى النهار على الترتيب.
وفيه يقول الشاعر اللبناني إيليا أبي ماضي:
وصــرت عقــدا لك أو خاتما :: في جيدك الناصع أو إصبعك
وقد جاء في الشطر الأول بالعقد والخاتم، وذكر ما يتصل بهما في الشطر الثاني، فالجيد مذكور للعقد، والإصبع مذكور للخاتم، حسب ما تؤكده القرائن المعنوية.
اللف والنشر المشوش:
ومثاله “هو ليل وورد ومسك، خدا وأنفاسا وشعرا”
فالليل في المثال السابق تعبير عن سواد الشعر، والورد عائد إلى الخد، والمسك للأنفاس.
اللف والنشر المعكوس:
ومثاله قول لمغني:
هذا من ش لِ فيك أتفاك :: من تخوافك لِ والتطماع
ما خـلاهـــا بي تظيـاك :: ولا خلاهــا بـي توســاع
فالضيق في التافلويت الثالثة عائد على “الخوف” والاتساع في التافلويت الرابعة عائد على “الطمع”
يرى الأستاذ محمد ولد إمام أن البعض قد درج على تعريف اتروسي بأنه مقابل مكافئ لما يعرف باللف والنشر في علم البديع، لكن ثمة اختلاف بينهما. فاللف والنشر ويسميه بعضهم «الطيّ والنشر». أسلوب بديعي مشهور عند البلاغيين، وهو بحسب تعريف الخطيب القزويني في الإيضاح “ذكر متعدّد على جهة التفصيل أو الإجمال، ثم ذكر ما لكلّ واحد من غير تعيين، ثقة بأنّ السامع يردّه إليه” والأمثلة عليه أكثر من أن تحصى في النثر والشعر.
اتروسي
“اتروسي” هو ذكر متعددٍ تفصيلا على الوجوبِ، لأنه كما ورد سابقًا لا يمكن أن يبدأ بمجمل يأتي تفصيله لاحقا كما هو الحال مع اللف والنشر. وهذا المتعدد الذي ذكر في البداية هو نفسه الذي سيُعاد ذكره لاحقا.
ومثال ذلك:
ما رينَ فرق إيبان اكبير *** مول الطشه هون أبدارُ
ويعـدل مــارُ، والفقـيـر *** أبدارُ ويعـــــــدل مـــارُ
في هذا الكاف نلاحظ تكرار الكلمات نفسها بين “التيفلواتن” الثانية والثالثة والرابعة، وبالمعنى نفسه، لكن مع إضافتهم في المرة الأولى إلى الغني، وإضافتهم لاحقا إلى الفقير.
وينقسم “اتروسي” كما هو الحال مع اللف والنشر إلى ثلاثة أقسام -وقد يكون ذلك مما أشكل على البعض، فأصبح يستخدم كل واحد منهما للتعبير عن الآخر، دون عناية بدقة التعبير أو سعي إلى التأكد من دلالة المصطلح-
وهذه الأقسام الثلاثة هي:
اتروسي المرتب:
ومثاله قول الطيب ولد ديد:
أشمــرنِ يالحــي المتيـن :: مديــن وعريــان ودافر
ومسافر، واشمرن مدين :: وعريان ودافر وامسافر
اتروسي المعكوس:
ومثاله قول امحمد ولد أحمد يوره:
كنت أنظن أنّ كان أبعـدت :: منك نكــر هــــاك ونثبت
وانحل الراص، ولا خلكت :: مـــانـــل يانَ مـــا حليت
الــراص ومـــانل ما فــت :: زاد اثبت ولا فت أكريت
اتروسي المشوش:
ويقول فيه امحمد كذلك:
هذو هون ادويرات إلاه :: امن اديار البيه التولاه
وحده عند المان افمگفاه :: أُوحدَة عند المارد تلُ
اوحدَه عند انِيذنينْ احذاه :: حــد اتفگـدهَ تحـجــلُ
فاتت نوبتهم غير امنين :: فاتت ذاك المـارد تلُ
مــزال افبــلُ وانيـذنين :: افبــــلُ والمـــان افبلُ
يرى الأستاذ ممو ولد الخراشي أن لا علاقة بين اتروسي واللف والنشر، فهذا الأخير محسن معنوي، لا أثر له في حد ذاته، في البناء الصوتي. أما اتروسي فهو تكرار. ومعلوم أن البلاغيين العرب القدامى والعروضيين، لم يهتموا بالتكرار رغم قيمته المعنوية، والإيقاعية، ووجوده في الشعر الجاهلي، واستقبحوه في الضرب وسموه إيطاء.
ومصطلح “اتروسي” هو المقابل الحساني لكلمة تكرار، لكنه تكرار منتظم، فهو كلمات “تُحمل، وتُوضع”، كما يَحمل شخص واحد أمتعته بالتفاوت. أما في الشعر الحديث فيرى ممو أن التكرار بات من الجماليات المستخدمة كثيرا، وله وظيفة معنوية تنضاف إلى وظيفته الصوتية الظاهرة، و”اتروسي” وجهه الحساني، وينقص من قيمته أن يكون متكلفا.
ويقول ولد إمام: اتروسي من المحسنات اللفظية المتداولة كثيرا في الشعر الحساني، وهو تكرار كلمات (أماكن مثلا) بترتيب أو من غير ترتيب في بداية النص وفي آخره.. أحيانا بمقارنة بينهما، وهو مختلف عن اللف والنشر من حيث إنه مجرد تكرار للكلمات دون تفصيل.
ولعل من أروعه قول ابن المعلى:
أمن مغني كافيك وآجـــــــــلاجْ الدَّايم والشوفَ
أمغني يوفَ وآجْلاجْ *** يوفَ والشوفَ توفَ
وتأسيسا على الأمثلة السابقة، أعتقد أنه يمكن الجزم بوجود اختلاف بيّن بين اتروسي واللف والنشر، ولكن هل يصل هذا الاختلاف إلى درجة أنه لا علاقة بين الأسلوبين كما قال ولد الخراشي، وأكد ولد لمام؟ أم أن العلاقة بينهما علاقة الجزء بالكل كما يرى الأستاذ الطالب ولد سيدي المصطف.. الذي يؤكد أنه لا يمكن نفي وجود اختلاف بين الأسلوبين، ولكن لا يمكن في الوقت نفسه القول إنه لا علاقة بينها تماما.
وختاما أضع هذا السؤال الكبير بين يدي القارئ ليحكم بنفسه على ما عرض من أمثلة وبسط من تعريفات ومفاهيم، ولكن قبل ذلك وبعده أريد أن أسأل سؤال آخر.. لماذا نبحث في كل أسلوب من أساليب الشعر الحساني عن صلة تربطه بنظير له في الشعر الفصيح؟